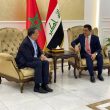تتسابق الأحزاب السياسية هذه الأيام لتقديم مذكراتها إلى وزارة الداخلية بشأن المنظومة الانتخابية المقبلة، لكن ما يروج في الكواليس، ونحن على بعد يوم واحد من الأجل الذي وضعه وزير الداخلية لأمناء الأحزاب السياسية، يكشف أن الخوف الأكبر ليس في شكل القوانين، بل في شبح العزوف الانتخابي. أغلب المتابعين للشأن السياسي ببلادنا ينبهون إلى نسب مشاركة قد تكون كارثية، وتصف المشهد بكونه تهديداً مباشراً لشرعية العملية الديمقراطية برمتها. المواطن البسيط، وقد أنهكته سنوات عجاف، لم يعد يجد سبباً مقنعا يدفعه إلى التصويت في صناديق الاقتراع.
المواطن يرى بأن عينه الأداء الهزيل للأحزاب السياسية، وإصرارها على إعادة تدوير نفس الوجوه، وتغذية مشهدها بممارسات سياسية بالية، كلها أسباب تدفع الناخب إلى إدارة ظهره.
في البرلمان، يمكن أن نجد الزوج نائباً والزوجة عضواً في الجهة المقابلة، والأبناء موزعين بين الغرفتين. أما التزكيات، فهي في كثير من الأحيان حكر على “الأعيان” الذين يملكون أكثر مما يملك المناضلون والكفاءات. وحتى لوائح الكوتا، التي كان يفترض أن تجدد النخب، تحولت إلى آلية لتوزيع الامتيازات على المقربين والصديقات. أمام هذا الواقع، يصبح الحديث عن “المشاركة الواسعة” مجرد وهم لا يصدقه أحد.
المواطن اليوم لم يعد يبحث عن خطابات مكررة ولا عن وعود فضفاضة. هو يريد وجوهاً نظيفة، صادقة، قادرة على إقناعه بأن ورقة التصويت ليست عملاً عبثياً. فإن بقيت الأحزاب وفية لعاداتها القديمة، ولم تجرؤ على مصارحة نفسها قبل مصارحة الناس، فإن أي محاولة لتحفيز الناخبين ستظل مجرد ذر للرماد في العيون.
إن الخطر الداهم لا يكمن فقط في العزوف، بل في تحوله إلى قناعة جماعية بأن السياسة عبء لا طائل منه. وحينها لن يكون ما ينتظر البلاد مجرد نسبة مشاركة ضعيفة، بل انهيار كامل في الثقة قد يكتب شهادة وفاة الحياة السياسية. تلك هي الخطيئة القادمة، وإذا لم تعترف الأحزاب بمسؤوليتها في صناعتها، فلن ينفعها تبرير ولا خطاب.
إنّ مأزق الأحزاب اليوم ليس في عجزها عن الفوز بمقاعد، بل في عجزها عن إقناع الناس بأنها تحمل مشروعاً يتجاوز الانتخابات. فحزبٌ بلا رؤية مجتمعية كالسفينة بلا بوصلة، قد تُبحر لكنها لا تصل. وما لم تُدرك هذه القوى أنّ السياسة أوسع من صناديق الاقتراع، وأنّ المجتمعات لا تُبنى بالشعارات الموسمية بل بالمشاريع الكبرى، فإنها ستبقى تدور في الفراغ، فيما يظلّ الناس يبحثون عمّن يمنحهم معنىً وأملاً.