لسنوات، اختار المغرب أن يكون الهادئ في قارة تعج بالضجيج، وأن يرد بالحكمة حيث يرد الآخرون بالصراخ، وبالاستثمار حيث يختار غيره التحريض. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم بإلحاح: هل تحوّل هذا الهدوء إلى تساهل؟ وهل صارت الضيافة المغربية مبررا لغض الطرف عن الأخبار الكاذبة والحملات المغرضة.
بدعوى حسن النية، تساهلنا كثيرا مع ظلم صريح صادر عن بعض الدول الإفريقية. فتحنا الأبواب ومددنا اليد، لكننا لم نكن ننتظر هذا الكم الكبير من الحقد والكراهية الذي انفجر، للأسف، من جهات كان يفترض أن تكون شريكة لا خصما. وما حدث من موجات عداء غير مبررة، خصوصا من السينغال، ليس سوى عرض لمرض أعمق: فراغ الساحة من خطاب مغربي قوي، حاضر، ومضاد للأكاذيب في وقتها.
أين هم المؤثرون الذين “سخنت” بهم جامعة كرة القدم “أكتافها”؟ أين الأصوات التي كانت تملأ الشاشات والمنصات عند أول دعوة أو أول امتياز؟ لقد “ذابوا” جميعا مع صفارة حكم مقابلة النهاية، وكأن الوطنية عقد موسمي، أو ترند يستعمل ثم يرمى.
وهنا السؤال الأكثر إيلاما: هل لو كنت تحمل بين أضلعك سيدتي المؤثرة، أو كنت تحمل بين صدرك سيدي المؤثر، وطنا، ستنتظر أو تنتظرين “Collab” للدفاع عن بلدك؟ هل صار الدفاع عن المغرب مشروطا بعدد المشاهدات؟ أم بمقابل مادي؟ أم بموافقة مدير أعمال؟
الحقيقة التي يجب أن تقال بلا تزيين: “لي مغطي بمؤثرين أجانب عريان”، ومن يراهن على أصوات لا تنتمي إليه، سيفاجأ يوم الشدة بأنها أول من يصمت، أو أول من يطعن.
المغرب اليوم في حاجة ماسة إلى نموذج جديد للتواصل. نموذج لا يكتفي برد الفعل، بل يصنع الرواية. نموذج لا يتسامح مع الأخبار الكاذبة، ولا يتركها تنتشر باسم الهدوء أو الدبلوماسية. نموذج يحمل المسؤولية لكل من يستفيد من اسم المغرب، ثم يختفي عند أول اختبار.
الدبلوماسية لا تعني الصمت أمام الكذب، والحكمة لا تعني ترك الساحة للعدميين، والضيافة لا تعني أن نفتح بيوتنا لمن يسيء إلينا ثم نبتسم.
لقد آن الأوان أن نفهم: الأوطان لا يدافع عنها بالنوايا الحسنة فقط، بل بالخطاب القوي، والحضور المستمر، وعدم التساهل مع المغرضين، مهما كانت صفاتهم أو جنسياتهم.






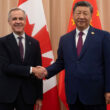



المطلوب اقتراح تصور لما سمي “نموذج تواصلي جديد للمغرب” لمقارعة التواصل الانتهازي الكاذب ضيق الأفق. وإلا سنتوقف عند حدود التشخيص. عندئذ يمكن قياس مدى جدارة المدافعين عن قضيا الوطن ومكانته